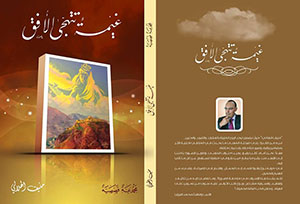- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
- بعد أن تلقوا ضربة أمريكية موجعة... الحوثيون يعلنون خفض التصعيد في البحر الأحمر
- مسلحون حوثيون بقيادة مسؤول محلي يقتحمون منتجع سياحي في الضالع للبسط عليه
- جزيرة كمران.. قاعدة عسكرية لإيران (تفاصيل خطيرة)
- "تهامة فلاورز" مشروع الحوثيين الوهمي للاستيلاء على أموال اليمنيين وأراضي الدولة

وكان الإنسان عجولا، ما رأيك؟
- صحيح رغم أنه يعرف أن حتفه قادم، في ثنايا العجلة، لكنه يستعجل الغد، لأن الأمل أقوى من الموت.
هل أنت عجول؟
-جداً، حتى في الكتابة، وكأني أريد التخلص من شيء ثقيل والهروب من لحظة الكتابة. نعم أعترف لك أنني عجول في كل شيء، ومتعجل حتى في تفاصيل حياتية عادية، حتى أني كتبت في قصيدة (أفكر في الوردة)، والتي نشرت في مجموعتي الأخيرة، "جسد للبحر رداء للقصيدة"،
(ولأني متعجلٌ نحو الوردة
مستغرقٌ في تفكيكِ أواصر علاقتها بالريح
متشككٌ في قدرة الماء على إحباط رغبتها في الشذى
أسلكُ طريقاً مغايراً للشوك
أفتح باباً موارباً للحياة
أمطُّ تاريخَ الاسفنج
وأغفو عندَ يَدِ المعنى).
متعجل في كل شيء، إلا في الحب، فلدي صبر على ذلك ورغبة في عدم الانتهاء، وكأن الموت في الحب يصير لذيذاً وأبدياً.
إذن كيف تولد القصيدة لديك، في لحظات، أم تأخذ زمنا؟ وهل تخضع لعملية جراحية أم أنها نص مقدس لا يمكن التصرف فيه ومعه؟
-لكل قصيدة حالة ولادة مختلفة، أحياناً تتعسر، ولا يتكون حمل، وأحياناً يتكون حمل، ولكن وقت الولادة لا ينتج شيء. وقد يأتي وليد مكتمل وبعافية، وأحياناً يكاد يطير من رغبته في الحياة؛ كل مولود، له حالته الخاصة، وكل قصيدة لها ميلادها، وظروف تكونها وانطلاقها. ولكني لا ألجأ إلى العمليات القيصرية، بل أتناسى الكثير من حالات الحمل، لظروف ما، فتتلاشى القصيدة التي لم تتبلور ولم تتخلق.
النص لا يكون مقدساً إلا بعد الولادة الطبيعية، والنمو الطبيع. وحين ينمو بشكل صحي وصحيح، ربما يصبح مقدساً أو لُنُعرِّف التقديس هنا باعتباره عدم تدخل في الخلقة بعد التكون والنضوج؛ حيث لا يمكن أن تفكر بعملية تجميل لصبية ناضجة وجميلة. لا أميل إلى عمليات التجميل ولا أتخلى عن أطفالي في كل حالاتهم.
لدى قصائدك – أو التي رأيتها أنا- نكهة حزن وذائقة غربة. هل هي ضائقة فردية أم ماذا؟
-ربما فردية بنسبة قليلة، لكن الحزن لدي حزن معتق من قبل الولادة، حزن تراجيدي. تخيل أن تولد في وطن ثلاثة أرباعه محتل احتلالاً استطيانياَ، وأقل من ربعه موزع بين دولتين، وهويتك مغيبة داخل هذا الوطن الذي تراه يضيع منك، قبل أن تتلمسه، وتشعر بدفء حضنه، بل تفهم منذ الصغر أنه يحتاج إلى حنان طفل مثلك، وكتف تتكئ عليه، وطن يحتاج صغاره قبل كباره، تشبُّ قليلا لتلهو؛ فترى الدبابات الإسرائيلية، تهدم بيوت بلدتك، وملاعب طفولتك، وألعابك، وبعد أيام ترى الاحتلال العسكري، يكمل تمدده على باقي بلادك، وتشعر بانهيار كل الثوابت حولك، وترى رأي العين، تهافت شعارات كثيرة تتغني بالعروبة والإسلام والثورة والثأر.
تولد طفلاً خاسراً، فكيف يمكن أن تشعر بغير المأساة وأنت تسمع كل قصص السمر والسهر تدور عن الموت والضياع والاحتلال؟ بل وكيف يمكن أن تتناسى قيمة الوطن وحتى الغناء يتمحور حول الشهادة والوطن الضائع؟ لهذا تربيت على حزن فردي، وتراجيديا جمعية، تضاهي كربلائيات الحسين، وحزن الشيعة، على وطن يذبح أمام عينيك، ومستقبل غامض، وغد مجهول، وخسارات متلاحقة، تعزز آلامك الفردية والجمعية، حتى يسكن فيك؛ كما ورد في قصيدة لي:
(حزن بلاد خدعتها الكتب
.... ضيعتها الوشايات).
إن الإنسان لفي خسر؛ ماذا خسر موسى حوامدة في حياته ويتمنى استرجاعه؟
- أكبر خسارة؛ خسرتها في حياتي، وحتى في مماتي وبعده، هي وطني، سواء في احتلاله، أو في عيشتي بعيداً عنه. قد أكون محظوظاً إلى حد ما، أني ولدت فيه، بينما ملايين الفلسطينيين ولدوا في المنافي والشتات، ولكن تخيل أن تولد في وطن ليس لك، وأن تعيش في منفى بعيداً عنه؛ وليس البعد الجغرافي فقط، بل أن ترى مستوطنين يقيمون في بلاد هي لك، وفوق رؤوس جبال كانت لأجدادك وأهلك وشعبك، وترى مخلوقات لا تشبه جبال بلادك ولا ثقافتك، ترى بشراً غريبين كأنهم شياطين، جاؤوا في ليل بهيم، يقتلعون سكاناً طبيعيين من بلادهم، ويسكنون محلهم، يجرفون أشجارك وزيتونك، ويقتلعون جذورك من تراب وطنك، حاملين معهم خرافات تؤكد حقهم في بيتك وأرضك وتاريخك. والمصيبة أن كثيرين من البشر وقليلين من أمتك صدقوا ذلك، وبعضهم وإن رفض الاحتلال ظاهرياً، لكنه يطبق خرافاته عملياً على الأرض حتى من مثقفين كبار.
ولكن رداً على سؤالك وعما أتمنى استرجاعه، قل لي الآن لو رجع الوطن المفقود، كيف تسترجع عمراً كاملاً قضيتَه بلا وطن؛ لا شيء يمكن أن يعوض عن هذا الفقد وحتى بعد الموت، ستظل عظامي تدرك أنها عاشت بلا وطن، وليس الوطن هو المكان فقط أو الأرض، بل الوطن هو كل شيء من تراب وبلاد، من هواء وحرية، وسذاجة تماهي معك التاريخ، وتمنحك ذلك الشعور بالطمأنينة، وعدم النقصان؛ ذلك الشعور الذي يجعلك لا تدرك معنى الوطن، ومعنى أن تكون حراً في شتم هذا الوطن، ساعة تشاء، فلم يخلق الوطن للعبادة والتقدس والاستشهاد فقط، بل للنفور منه، وعدم تقديسه. ولكن قبل ذلك لا بد من كينونته أولاُ؛ سبحان الله لم أشعر بشعور الكراهية، تجاه بلدي، وكم كنت أتمنى أن يمنحني ذلك الشعور لأمارس إنسانيتي أكثر من الاتكاء على جدار مهدم، ولا أدري من فينا الجدار المهدم، أنا أم هو؟
• يقول محمود درويش وطني حقيبة ويقول آخر وطني لغتي. أين وطنك يا ترى؟
- حين يقول شاعر ما وطني ليس حقيبة فهو من الذين يتشبثون بأرضهم ولا يسافرون، أما درويش رحمه الله فكان دائم السفر، وكانت مقولته هذه رداً عليه؛ مع أن الحقيبة لا يمكن أن تكون وطناً حتى شعرياً. لكن نحن نردد أحيانا جملاً، لا نفكر فيها بعمق، وأدونيس قال وطني لغتي، وربما أدونيس أقرب للمعنى الشعري، ولكن بالنسبة لي وطني هو فلسطين من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن، ومن لبنان شمالا إلى رفح جنوباً. وحين أشعر بحريتي في هذا الوطن، سأفكر باللغة وبالقصيدة وحقيبة السفر، وما دام هذا الوطن ليس في قبضتي، فكل وطن أدعيه مجرد خيال مريض، لا معنى له، حين أقف بصلابة على صخرة، فوق جبل من جبال الخليل، وأشعر أنني كائن حر فوق بلاد حرة، سأتخيل وطني غيمةً تجوب المجرات، ولدي خيال سيسعفني للذهاب إلى أقاصى السوريالية.
• هل الوطن عادة؟ حالة؟ ظاهرة؟ سلوك؟ أمنية؟ أم جغرافيا يعيشها الشاعر؟
- الوطن حياة كاملة، منذ تلك الطلقة الأولى التي تطلقها الأم، وحتى تلك التنهيدة التي تشهقها، بعد الولادة، إلى تلك الرائحة التي يتنفسها وليد قادم، إلى عالم غامض، إلى قطرات الحليب التي ترضعها، وحروف الحنان التي تقطرها، الأم في فمك، رويداً رويداً وحتى بداية تلعثمك بحروف الجغرافيا، وكلمات الجسد، التي تبدأ تتلمسها منذ اللثغة الأولى. هذه هي بداية الوجود الذي يتبلور كل مرة في شكل جديد، وبطريقة مختلفة، لكنه تتابع للحالة الأولى، وإعادة تمثيل لتلك اللحظة التي تشبه لحظة انطلاق بتلات الوردة، من قبضة اليد المغلقة، وحتى إطلاق صرخة؛ صرخة لون، صرخة كلمات، صرخة موسيقى، صرخة حياة، صرخة حرية، صرخة صلاة، صرخة مدوية، تنم عن خلق جديد، يولد في أقل من هنيهة في الزمن.
• الوطن؛ علاقة ثنائية بين الإنسان والمكان، إذا أحب بعضهما البعض، تكتمل المعادلة، وإلا سيكون الوطن منفى آخر. ما رأيك؟
- نعم صحيح، في حالة تحقق وجود الطرفين معا، وغربة الإنسان عن المكان ليست بالضروة كراهية بين الاثنين؛ ربما يشعر المرء بالغربة، حتى بين أهله وفي مسقط رأسه ولكن حين لا يوفر الوطن للإنسان ذاك السرير الملائكي بعد الولادة ولا يعيره اهتماما ويضيق عليه الخناق أو يخذله على كبر، ولا يجفف دموعه إن هطلت، ولا يمسد رأسه إن مرض، فما قيمة هذا الوطن؟ ليست قيمة الوطن في الصخور والتراب والشوارع والبيوت، وإلا لكان الإنسان يبحث عن مكان يوفر له سبل العيش وينسى مسقط رأسه، وهذا لا تقبله الغريزة نفسها، فالوطن هو الفضاء الذي يمنحك كل شيء حتى حقك في كراهيته والنفور منه.
أما أن يصر الوطن، على كون الإنسان طالباً في الصف الأول ابتدائي، وأن يظل يردد له أناشيد وطنية تثبت حب الإنسان لوطنه، فهذا أمر بدائي جداً، وينم عن تخلف. على الوطن أن يفتح حدوده للإنسان، ويطلق حريته، ليس للدخول إليه فقط، ولكن حتى للطيران والهروب.
• سابقاً كانت القصيدة تقلق الكراسي والعروش. ماذا عن القصيدة الراهنة؟ ما مدى فاعليتها؟ وما هو المطلوب منها؟
-سأجيبك هنا بصراحة وبقناعتي، وليس انجرارا وراء رأي عام؛ ليست مهمة الشعر، أو القصيدة إقلاق العروش والكراسي، أو شتم الزعماء، بشكل مباشر، فهذه مهمة الثورات أو التنظيمات والأحزاب والإعلام؛ وذلك لا يعني أن يكون الشعر مدجناً، أو يسير في ركاب أحد، أو في ظل زعيم، او حاكم، بل على العكس المطلوب منه النفور من الأنظمة والسلطات. ولكن من خلال تجارب شعرية عربية كانت تهجو بعض الأنظمة رأيناها تأوي تحت جناح سلطة ما.
في رأيي؛ أن وظيفة القصيدة تتعدى الشتم والسب العلني، أو وصف هذا الديكتاتور، أو ذاك الطاغية، وإن جاء ذاك عفو الخاطر، فليكن. ولكن إن كان مقصوداً، سيدرج القصيدة ضمن قائمة المهمات، والوظائف المطلوبة، منها للشعر. وليس للشعر إلا مهمة وحيدة، وهي تطوير الذائقة الجمالية للقارئ، والمستمع، وليست وظيفة الشعر رص الصفوف، وجمع المناوئين والمعارضين، وقد رأينا أن الشعر السياسي يفقد الكثير من جمالياته، مهما حاول نقاد نفخه وابتكار معان غير موجودة فيه.
لا يعني هذا ألا يكون للشاعر قضية. لكن شتان بين القضية الجوهرية التي تتبناها القصيدة وصاحبها، وبين القضايا الدعائية التي يعمد لها بعض الشعراء، لجذب التصفيق والإعجاب البسيط والسطحي.
وصدقا لا تغريني مثل هذه الوظائف، ولا تستهويني، ولذا أرى أن أجمل ما في القصيدة الراهنة، قدرتها على النمو بعيداً عن هذا الحزب أو التنظيم وهذا الزعيم أو النظام؛ للشعر وظيفة أسمى من وظيفة المهرج، والممثل، والناطق الرسمي، وهي حديثاً تلوي عنقها، وتبعد نفسها، عن الكثير من المتاهات والدهاليز العربية المظلمة.
بعض قصائدك – وكمثال قصيدة سلالتي الريح عنواني المطر المترجمة الى عدة لغات ومنها الفارسية - تجتاز فكرة الانتماء الضيق الى الجغرافيا والقوميات. هل تريد أن تقترب من فكرة التناسخ؟ وكيف تفسر ذلك؟
-لا، ليس التناسخ، وإن كنت لست ضد الفكرة نفسها؛ أعني فكرة التناسخ أو الحلول. لكن روحي تريد الإفلات من كل قيد، حتى قيود اللغة والعِرق والدين والجسد، وتريد أن ترى نفسها طليقة، لا تضع سداً أو مانعاً بينها وبين الآخرين. وإذا كان سارتر قد قال: إن الآخرين هم الجحيم، فلعلي أجد الجحيم في الأقربين أيضاً؛ فالجحيم لا طرفَ ولا جهة، أو قومية له، فالبؤس موجود في داخل كل واحدٍ منا، وليس بالضرورة أن يكون الشر في الآخر فقط، أو أن يكون المخالفون لي هم الجحيم فقط، لي جحيمي أنا أيضاً، وجحيمي داخلي، بل ربما جاءتني النار من خندقي، وكما قال ييتس: (لا أعادي الذين أحاربهم)؛ لهذا لم أعد أثق بالعصبيات والحدود الوهمية التي يضعها العقل على نفسه. الحياة أرحب من الضيق، والترجمة اليوم تكشف أن مشاعر البشر واحدة، وأن الحزن واحد، وليس مرتبطاً بدين أو لغة، وأن العذاب البشري واحد. نعم ربما وحدة الوجود التي نادى بها كثيرون قبلي من عمر الخيام، إلى مولانا جلال الدين الرومي، إلى الحلاج من قبله وغيره من المتصوفة. ولكن حتى بعيداً عن كل هؤلاء لا أشعر برغبة في الانعزال عن الشمس، وأعرف أنها ملك لكل البشر، والذين يريدون حشر الشمس في غربالهم لن يفلحوا مطلقاً.
كيف ومتى بدأت رحلتك مع القصيدة؟ ما هي المصادر والينابيع التي ساعدتك لخوض غمارها؟
-كثيرة هي المصادر والدوافع والينابيع، وربما كان أولها ذلك الأسى الشخصي الذي كنت ألمسه في حكايات ووجوه رجال القرية الذين كنت أستمع لأحاديثهم وحزنهم على وطن يتمزق بين أيديهم. وساهمت والدتي التي كانت تروي لي حكايات مختلفة عن تلك الحكايات المألوفة في تعزيز اهتمامي بالمعرفة، وكانت طريقتها في تبديل الحروف في كل مرة تروي لي الحكاية فتدبل أواخر الكلمات، وأحيانا الكلمات ذاتها، هي التي فتحت لي آفاقاً لمعرفة شيء من أسرار الكتابة، وهو التلاعب بالحروف والكلمات والجمل. بعد ذلك كان شغفي بالقراءة، قد فتح أمامي آفاقاً لقراءة كتب مثل ألف ليلة وليلة، ثم بعض الروايات الفلسطينية، مثل عائد إلى حيفا لغسان كنفاني، والولد الفلسطيني لمحمود شقير؛ ومن ثم رفضي قبول نصيحة مدير المدرسة والمعلمين بالذهاب إلى الفرع العلمي، واختياري للفرع الأدبي، منحني مجالاً لقراءة الكثير من القصائد والخطب، والتعرف على قواعد اللغة وعروض الشعر. ثم جاءت دراستي الجامعية فاخترت اللغة العربية، والتي جعلتني أتعرف بداية على الشعر الجاهلي الذي عشقته كما عشقت لغة القرآن الكريم، والكثير من النصوص النثرية القديمة. لكن دافع الكتابة الأول، كان شعوري بالألم، وإحساسي بالخسارة والفقد، وتلك الحساسية المبكرة والإدراك المبكر أنَّ لي وطناً لا أملكه.
• ماذا تتذكر من المكان الأول؟ هل تكتفي بالأحلام؟ أم قد يدفع بك الحنين كي تمرق إليه خلسة؟
-هذا كعب آخيل الذي يؤلمني. إنني مفجوع لفقده، عدم القدرة على العودة إليه، وزيارته كيفما أرغب. كل ذلك، أعتبره مكيدة لإبعادي عن مكاني الأول الذي ظل يلازمني، ويعيش داخلي، بدل أن أعيش فيه... وكما توقعتَ صديقي فأنا حالياً ألجأ للأحلام فعلاً، كي تخفف قليلا حدة غضبي، ويقل شعوري بالحرمان. أتخيل تلك الأماكن، وآثار الذين رحلوا والذين يواصلون الرحيل، فيزداد حزني؛ ليس لفقدهم فقط، ولكن لعجزي عن الوصول إليهم، وتلمس أثار أيديهم، وتلك الخطى المتلاشية.
• القصيدة الفلسطينية، ومنذ روادها في الستينيات، هل خدمت القضية؟ ما نوع خدمتها؟
-بالتأكيد خدمت القضية الفلسطينية في جانب إعلامي ودعائي؛ لأنها كرَّست فلسطين كموضوع رئيسي فيها، وعرَّفت القارئ العربي على قضية شعب بسيط نُهبت أرضه. لكنها ظلت تلهث خلف رضا القارئ العربي، ومقاييسه، وظلت حبيسة أدراج النقاد العرب، فلم تكسر عصا الطاعة، وتبرز من هذه القسوة والخسارة مدرسة شعرية جمالية يشار إليها عالمياً، فظلت تعرج خلف رضا المدارس العربية، بينما كان يمكن للقصيدة الفلسطينية أن تكسر تابوهات كثيرة، وتكرس حالة إنسانية، وليس ظاهرة سياسية في محيطها العربي الضيق فقط.
• أين يقع الشعر الفلسطيني في خارطة الشعر العربي؟
-ليست القضية قضية منافسة أو خطاً بيانياً في الشعر العربي؛ فظروف كل قصيدة لها خصوصية معينة، وإن كنا جميعاً نكتب قصيدة عربية، إلا أن القصيدة في فلسطين، يجب أن تكون مختلفة بالضرورة؛ لأنها تحمل تاريخ فلسطين منذ بداية القرن العشرين، بكل تشعباته وخرابه وانسكاراته. ولهذا فإن حجم الألم لا بد أن يكون أكبر تأثيراً وأثراً، وحجم الأمل لا بد أن يكون أكبر، وصوت الظلم لا بد أن يكون صارخاً في البرية بشكل أعلى وأعمق صدى.
وهنا لو تسألني هل كان الشعر الفلسطيني على مستوى القضية الفلسطينية، سأقول ببساطة لا، لأننا لم نحقق بعد خطاً أو لوناً أو طريقة أو ملاحم شعرية، تليق بقضيتنا العادلة، وبلادنا السليبة، وكأن مساحة الشعر الفلسطيني، كانت عربية الأفق فقط، تنافس القصيدة العربية في الجوار العربي فقط، بالرغم من أنها حملت أمراض القصيدة العربية، وكان يجب أن يكون الاختلاف واضحاً، والفضاء الفلسطيني، كان لا بد أن يكون مختلفاً ومتميزاً، وكان يجب أن يكون مجاله وفضاؤه أكثر اتساعاً.
• عبرت مئات القصائد الفلسطينية الى اللغة الفارسية بحيث صار الشعرالفلسطيني مألوفا عند الشعراء الإيرانيين. ماذا تعرف عن الشعر الفارسي؟ هل يستهويك شيء منه؟
- ونحن أيضا بتنا على مسافة قريبة من الشعر الفارسي؛ قديماً سواء في شعر الشيرازيين حافظ وسعدي، أو حتى شعر مولانا جلال الدين الرومي الذي كتبه بالفارسية، وشعر عمر الخيام الذي ترجم إلى أكثر من أربعين ترجمة عربية أيضاً، وكتاب منطق الطير لفريد الدين العطار الذي أثر كثيراً في الأدب العربي، والفردوسي في الشاهنامة، وحديثا في شعر الكثير من الشعراء المعاصرين أمثال نيما يوشيج، وأحمد شاملو، فروغ فرخ زاد، وسهراب سبهري وأعشق قصيدته المسافر، وغيرهم.
أحس في الشعر الفارسي الذي تسنت لي قراءته مترجماً أن هناك حنيناً للإنسانية أكثر، حنينا للفردوس البري المفقود، بلغة أقرب إلى التصوف والشفافية؛ ولعل ذلك
عائدٌ الى تلك الروح الجميلة لدى الشعب الإيراني والاعتداد بالقومية الفارسية، ولكن ضمن رؤيا كونية واسعة، وليس في إطار ضيق ومحصور عبر وفي اللغة فقط.
• زرت إيران قبل سنوات، وأظن أنك الشاعر العربي الوحيد الذي سافر إلى أبعد نقطة فيها، الى مدينة زابل في المثلث على حدود باكستان وأفغانستان، ماذا تتذكر من تلك الزيارة؟
-أتذكر هبوط الشمس قبل أوانها، أتذكر وقت الغروب يحل علينا مبكراً، وكأن المغرب يصلي صلاة العصر على ركبنا، أتذكر تلك الوجوه السمراء النقية، وأقدم مدينة في التاريخ، المدينة المحروقة، "شهر سوخته"، حين وقفنا عليها شعرت أنني في مدينة حية، رغم أن آثار تلك المدينة كانت قد اختفت منذ خمسة آلاف عام، أتذكر تلك اللحظات الرائعة التي قضيتها رفقة الشاعرين الرائعين الدكتور والمترجم الفذ موسى بيدج، والشاعر الشاب محمد حسين ناظمي، وطلاب جامعة زابل المحبين للشعر وللقدس وفلسطين وللمقاومة، وأتذكر ذلك الطعام المتقشف الذي كنا نتناوله مع الطلاب، وساعات النوم رفقة الأصدقاء، وذاك السوق العتيق الجميل، وكأنك في أسواق ألف ليلة وليلة، في تلك المنطقة العميقة من إيران، والعميقة في أفغانستان، العميقة في باكستان، وكأنك ترى ثلاث دول من نفس العائلة، وثلاث حضارات تمتزج معاً. ولعمري أن تلك الأيام لا تنسى فعلاً؛ فالناس عادة ما يتغنون بشيراز وتبريز وأصفهان، ولكن أن نذهب إلى زابل في آخر صرة الشرق الفارسي الجميل، فتلك كانت تجربة رائعة جداً، كتبت عنها مادة مطولة نشرتها بعض الصحف العربية، ولعلها ستظل لدي ضمن مشروع عن بعض الرحلات الخطيرة والتي لا تنسى.
لا أنسى ما حييت وجوه الطلاب والطالبات التواقة إلى سماع شعر فلسطيني مقاوم، ولا أنسى تلك الترجمة الرائعة التي قدمها الشاعر العذب والرقيق موسى بيدج، واختياراته الموفقة، وتلك الطريقة الرائعة في الإلقاء، ولا أنسى الحفاوة والترحيب والاهتمام الكبير، والروح الفارسية التي كأني أحسست بقبس منها.
• بصفتك شاعرا وإعلاميا وخبيرا في الشؤون الثقافية، ما هو السبيل للتعرف على الآخر؟ وكيف تعلق على ضرورتها؟
- لم أعد أؤمن بالآخر، صرت أكثر قناعة ألا آخر فوق الكرة الأرضية، وبالمناسبة فإن الآخر كلمة أو مصطلح نحته الغرب لازدراء الشعوب الفقيرة، منطلقاً من مقولة كيبلنج: (الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا) ومن تلك العنصرية الغربية التي بني عليها المستعمر الأوروبي والغربي أوهامه كما قال إدوارد سعيد. ولذا لا يجوز أن نكون ممن يؤمنون بالفوارق بين الغرب والشرق، لأن الآخر أيضاً جزء من البشرية ومن الإنسانية، وربما المشكلة فيّ أنا، وليست في الآخر، قد أكون أنا الأكثر عزلة، والأكثر اختلافاً عن الآخر. ولذا فمن الضروري أن أتعرف على الثقافة الإنسانية ما أتيح لي التعرف؛ وذلك يتأتى عبر الفنون والثقافة بأنواعها وعبر الترجمة. ولا شيء يُعرِّف البشر على بعضهم كما تفعل الثقافة والفن. وفي الفن هناك فنون مثل الموسيقى والرسم ليست بحاجة إلى ترجمة، وفي الشعر والرواية والكتابة عموماً، نحتاج إلى الترجمة وهي باب من أبواب التقارب بين الثقافات المخالفة؛ وذلك ضروري، بل صار في غاية الأهمية، كي لا يظل الإنسان أعرج يسير على قدم واحدة، أو يرى بعين واحدة وأحياناً مغبشة.
هنا تحدثت عن ثقافات مختلفة ومتباينة. أما بالنسبة للثقافات المتقاربة؛ وأخص العربية والفارسية والتركية والكردية، فإنني مؤمن تماماً بأنها ثقافة واحدة، يجب العمل الجاد، والتركيز أكثر وأكثر على حرية وانسيابية الكتب والترجمة بينها. وقد اشتركت مع الشاعر التركي الكبير حلمي ياووز، قبل سنوات، في حوار في استنبول عبر قناة آي آر تي، وكان حديثنا منصباً حول التقاء هذه الثقافات الشرقية، وضرورة التعرف على بعضها البعض مباشرة، ودون وساطة ثانوية؛ حيث أن أغلب الترجمات تتم عبر لغة أوروبية، وليست مباشرة.
منقول من مجلة شیراز...
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر