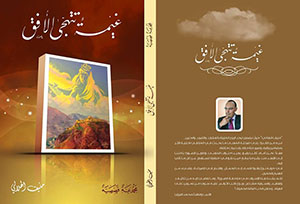- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
- بعد أن تلقوا ضربة أمريكية موجعة... الحوثيون يعلنون خفض التصعيد في البحر الأحمر
- مسلحون حوثيون بقيادة مسؤول محلي يقتحمون منتجع سياحي في الضالع للبسط عليه
- جزيرة كمران.. قاعدة عسكرية لإيران (تفاصيل خطيرة)
- "تهامة فلاورز" مشروع الحوثيين الوهمي للاستيلاء على أموال اليمنيين وأراضي الدولة

صدرت، مؤخراً، عن مؤسسة أروقة للدراسات والنشر في القاهرة الطبعة الثانية من رواية «جوهرة التّعْكر» للكاتب اليمني هَمّدان زيد دمّاج؛ وهي الرواية التي صَدرت طبعتها الأولى عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة عام 2015 إثر فوزها بجائزة الشارقة للإبداع العربي.
ينتمي هذا العمل إلى الروايات المفتوحة على آفاق قضية كبيرة انطلاقاً من واقع قرية الكاتب التي أراد لها أن تختزل معاناة بلده، الذي فقد بوصلته وغابت عنه سجيته ليعيش تغريبة طويلة، وذلك من خلال شهادة وقراءة تتمدد متجاوزة جغرافية القرية إلى أزمنة متعددة، لتستحضر مراحل تاريخية عديدة، من خلال رحلة غوص في ذاكرة وتأريخ المكان، القديم والوسيط والحديث، حيث تتوارى في أزمنته الحكايات والتفاصيل، أخبارها وأساطيرها؛ فمعها وجد الكاتب نفسه في مواجهة، بل مجازفة اكتشاف ما في (قعر) الذاكرة، التي لا نرى منها- عادةً- إلا ما يطفو على سطحها، بينما ما غاص في قعرها يبقى لها وحدها؛ «إلا مَن أراد الغوص في قعر الوعاء، بدون أن يعرف أهمية ما غاص من أجله، ولا إمكانية أن يطفو مرة أخرى على السطح.. حينها لن يكون في مجازفته تلك كمَنْ لم يعرفْ شيئاً وحسب، بل كمَنْ لم يكن على الاطلاق». والكاتب بهذا يكشف للقارئ، في أولى عتبات قراءة الرواية، حقيقة ما عاشه في تجربة كتابتها، حتى لا يصطدم القارئ بفجوات الهامش وقد صارت منصة للمتن، وبشخصيات الأساطير وقد صارت تمنطق الواقع.
بعد كل تلك الأسئلة التي تفيض بها القراءة يجد القارئ نفسه وقبل أن تنتهي الرواية أمام الراوي يتحدث إليه بخطابٍ مباشر مُحمَل بمزيد من الأسئلة؛ ولعل الكاتب بهذا الإمعان، يريد أن يؤكد منطقية تساؤلات القارئ، وربما –أيضاً- هي خشية الكاتب من احتمال ذهاب القارئ بعيداً عن حيرة الأسئلة ليقول: «هل أكتفي أن أخبركم بما لم يعرفه البعض من التفاصيل فقط؟ أم عليّ أن أشاطركم أيضاً ما يزخر به قاع الوعاء من الأسئلة، التي لاتزال بدون إجابات». وقبل أن يختتم الرواية يضع الراوي/الكاتب القارئ على حقيقة موت «العُمدة» وحلقة جديدة من المقتل الغامض لـ»كريم»، مع جرعة مترعة بمزيد من الغموض، عندما قال الراوي إن اسمه هو «كريم».
اللامعقول
اشتغلت الرواية بوعي على المعقول واللامعقول، في علاقتها بما عاشه وشاهده الراوي في القرية، وما قرأه الكاتب في رحلته في ذاكرة وتأريخ المكان؛ وهو الوعي الذي تجلى واضحاً في البناء الدائري للحدث الروائي؛ وهو وإن كان شائعاً في السرد الأوروبي ويظهر فيه مدى تأثر الكاتب بالرواية الأوروبية، وهو ليس مستغربا، وقد دَرس الكاتب وتخرّج وما زال يعيش في إنكلترا، إلا أنه كان متميزاً في إدراك ذلك الخط الرفيع بين الحقائق والأساطير، وبين المعقول واللامعقول في ما يرويه، وبين حكاية واقعه وحكايات الشواهد المستحضرة من أعماق ذاكرة المكان، علاوة على قدرته على الربط (بذلك الخيط الرفيع) بين وقائع عاشها ويرويها ووقائع يستشهد بها وينقلها، ما يؤكد أن رؤية الكاتب كانت أقدر على تمثل وبناء عالم يخصها وقد نقتنع به، استقراء لمعان بعيدة تستهدفها القراءة الموازية بوعيها للكتابة. على الرغم من أن هوية الكاتب هي الشعر فبه عُرف ومنه انطلق إلى القارئ، وعلى الرغم من أن هذه هي تجربته الروائية الأولى؛ إلا أن تأثير الشعر لم يظهر فيها، بل إن الرواية اتكأت على لغة واعية بأفكار ومنطق الرؤية التي تعالجها وتشتغل عليها؛ ومثل هذا الوعي العقلي النقدي الذي ينسحب حتى على اللغة ويتجاوز مناخ الكاتب الشعري يعكس وعياً سردياً عاليا.
الصيرورة
يبقى أسلوب البناء الدائري للحدث الروائي شائعاً في السرد الأوروبي؛ وقد اعتمد عليه هذا الكاتب إطاراً عاماً، لروايته من حيث الانتهاء بحدث يعود بشكل غير مباشر إلى نقطة البدء، في سياق روائي متسلسل بحلقات وحكايات متداخلة مثقلة بشخوص وأحداث تشغل (284) صفحة من السرد، الذي اعتمد في بنائه الداخلي، أيضاً، على دوائر بنيوية صغيرة عديدة تذكّرية وتركيبية، حتى كأن كل حكاية قد تفتح الباب لرواية أخرى، وأحياناً ومن وطأة هذا التداخل المتعدد قد يستعصي على القارئ الوعي بذلك الرابط الجامع للحكايات؛ فيعود للخلف قليلاً مستدركاً وعيه بذلك الخيط الرفيع.
ودائرة البناء السردي في الرواية الأوروبية تنطلق من وعي يؤمن بصيرورة الحكاية، كما يعتقد بأهمية الاشتغال السردي على الأفكار، لا على المواقف والأحاسيس (الفعل ورد الفعل)؛ ولهذا نجد الكاتب في هذه الرواية بقي يحاول ألا يقع تحت تأثير عاطفة انتمائه للمكان وللشِعر والتماهي بواقعية وافتراضية علائق الناس بالتاريخ، على الرغم من أنه لم يكن سوى شاهد على ناس عاش معهم، وكذا باحثاً في تاريخ هو تاريخ بلاده؛ إلا أنه ظل حريصاً على الاشتغال على شهادته وبحثه التاريخي انطلاقاً من القناعات التي يرى من خلالها مشكلة بلاده، في ظل ما تعرضَت له تحت تأثير الاستبداد السياسي وتيارات الإسلام المتطرفة والثقافات الوافدة؛ التي غيبت ملامح سجيته وتسببت في ظهور قناعات وعادات ومفاهيم عززت من عزلته، وساعدت على استمرار تغييب فاعليته وبالتالي تعثر تقدمه.
التعكر
اعتمدت الرواية على ذاكرة قرية «ذي المجمرة» الواقعة في وسط البلاد على سفح جبل التعكر؛ وهو جبل يحتضن مآثر لعصورٍ وحقبٍ تاريخية موغلة في القِدم، وارتبط ببعضها الكثير من الأساطير منها ذات العلاقة بساقية تنهمر من الجبل وتسقي القرية، ويطلق على هذه الساقية «الجوهرة»؛ ولتسميتها أسطورة متعلقة بشخصية «الحاج مُحُمَد»، التي أرودها الكاتب على هامش السرد، ومن تسميتها جاء عنوان الرواية؛ وهذه الأسطورة هي واحدة من أساطير عديدة ارتبطت بهذا بالجبل؛ بما فيها ذات العلاقة ببعض نقوشه وما افترضه البعض من علائق بينها وبين حوادث قتل عديدة فاضت بها ذاكرة المكان في هذه الرواية؛ وهي فرضية رمزية ربما أراد بها الكاتب التعبير عن مدى تعلق الناس بالأساطير، هرباً من مواجهة حقائق الإجهاض المتكرر لكل محاولات الحياة، وفي الوقت نفسه دعوة لإعادة الاعتبار العلمي لمثل هذه الأماكن والمعالم بدلاً من تركها عبثاً لهذا الفراغ.
بطولة المكان
على الرغم من مركزية شخصيتي «كريم» و«العُمدة» في مسار الحكي داخل الرواية إلا أن المكان يبقى هو بطلها الحقيقي؛ فأسئلة القارئ والكاتب لا علاقة مباشرة لها بشخوص الرواية، بقدر ارتباطها الوثيق بما شهده المكان؛ ولهذا اشتغل الكاتب على توظيف أخبار التاريخ، وما تكتنزه ذاكرته الشعبية؛ ولعل هذا الاشتغال الذي قد يكون هو هامش سرد ما يدور في القرية؛ إلا أنه، في الحقيقة وكما سبقت الاشارة، هو متن هامش حكاية القرية التي كان الكاتب حريصاً على ألا يرويها بعيداً عن خلفيتها المرتبطة بتاريخ وذاكرة المكان، باعتبارها هي المعنى للمبنى (الحكاية)؛ ولهذا كان يستغرق كثيراً في التعريف بالمعالم، ويتوقف أكثر أمام ما شهده المكان من حكايات ذات علاقة بحاضره، وبعض هذه الحكايات يعود إلى ما قبل الإسلام، كحكاية الكاهن سُطيح التعكر، الذي سُمّي الجبل باسمه، وغيرها من الحكايات ذات العلاقة بحوادث الموت الغريبة التي شهدها المكان واستحضرها الكاتب من مراحل تاريخية مختلفة وفق علائق معاصرة، كحكايات شهدتها الدولتان الصليحية والرسولية في التاريخ الوسيط للبلاد، وحكاية مرض ووفاة عالم النبات السويدي المستشرق بيتر فورسكال، خلال زيارته للمكان مع «بعثة نيبور» الدنماركية في القرن الثامن عشر الميلادي، وهي الحكايات التي حاول الكاتب الربط بينها بخيط (الموت اللغز) بما فيها مقتل بعض أعضاء البعثة الطبية الأمريكية المعمدانية في مستشفى جبلة القريب من المكان عام 2002، على أيدٍ رأى الكاتب أن لها علاقة أيضاً باغتيال سياسي كبير في صنعاء في العام ذاته. حكايات كثيرة شهدتها القرية/ المكان، وربط بينها الكاتب وحكايات أخرى من الذاكرة، كحكاية حادث سيارة «العُمدة» والموت الغامض لابن «الشيخ العارض» بالتزامن مع اغتيال الرئيس إبراهيم محمد الحمدي في صنعاء عام 1977. كل تلك الحكايات والمآلات لم تتوقف عندها الرواية، وفق ما يرويه التاريخ، بل تجاوزتها إلى ما حملته الذاكرة من حكايات شعبية كحكاية «طُواق العروس» مثلاً، لتأتي الرواية عبارة عن حشد ضخم للمتعلقات الحكائية (للمكان/ الوطن) في سياق خطاب سردي نقدي حاول فيه الكاتب أن يربط بين مقتل «كريم» وما شهده المكان والبلد من حكايات ومآلات يعجز الناس عن فهمها، فيلجأون للأساطير هروباً من مواجهة الحقيقة؛ لاسيما وأن لفهم وتتبع مسار هذه الحقيقة تبعات وثمن يتجنبه الكثير.
سينمائية التذكر
مقابل البناء الدائري المركب والمتداخل لا يمضي الخطاب السردي للرواية إلى منتهاه مغلقاً الدائرة؛ إذ تغيب الإجابات دائماً؛ لتبدو الرواية حلقات من الأسئلة؛ ولعل الكاتب بهذا (الخطاب المفتوح) يجعل من القارئ شريكاً في الكتابة، من خلال فاعليته في القراءة، لا سيما وأن القضية أكبر من اختزالها في رواية كهذه، وحتى إن اُختزلت فهي ستبقى مبتورة أو منحوتة وفق إطار صورة لا علاقة لها بالواقع، ولعل هذا ما يميز هذا الاشتغال على هذا النوع من الروايات، في علاقتها بحكايات منسية في تجاويف التاريخ والذاكرة غير المرئية.
استحضار التاريخ وتذكر المرويات، وفق رحلة وصلت إلى قعر الذاكرة، يجعل مهمة روايتها صعبة، يحتاج معها الكاتب إلى مهارة بنائية وخطابية لا يفقد معها النص حيويته السردية وخصوصيته الروائية؛ ولهذا لجأ الكاتب إلى سردية سينمائية من خلال الربط المتداخل والدقيق بين المشاهد والحكايات، في سياق معالجة استوعبت خصوصية واستنطقت مدلول تلك المرويات التذكّرية. ومثل هذه الأعمال لا تمنحها الرواية، غالباً، معالجة تكتمل فيها رؤية القراءة مثلما اكتملت رؤية الكتابة؛ ولهذا فإن هذه الروايات تكون أكثر الروايات نجاحاً سينمائياً؛ بل إن إنتاجها سينمائياً سيمثل عملاً موازياً ومُكملاً لقراءتها في الوقت ذاته؛ فالفيلم لن يقدم أسئلة بقدر ما يقدم الإجابات، وهو ما سيشعر به القارئ خلال مشاهدته للفيلم، فمثل هذه الروايات ذات العلاقة بالذاكرة والتاريخ تكون مليئة بالإثارة ومحشوة بالصور الكبيرة والرؤي التي تعجز الكلمة عن تفكيك معانيها؛ فكتابتها لا تنتج سوى مزيد من الأسئلة بينما (سيَنَمتَها) تكون قادرة على إنتاج مزيد من الإجابات، على الرغم من تحميلها حمولة أكبر من الخيال، لكن تلك الجرعات (الزائدة) تكون ضرورة سينمائية أحياناً تتجلى معها المعاني المحجوبة عن الكتابة، ولنا في عديد من روايات وأفلام التاريخ والأساطير في سينما الغرب دليل واضح على هذا؛ بل تعدّ هذه الأفلام من أكثر الأفلام العالمية نجاحاً على ما تثيره من أسئلة جديدة بشكل موازٍ لما تقدّمه من إجابات.
منقولة من القدس العربي..
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر