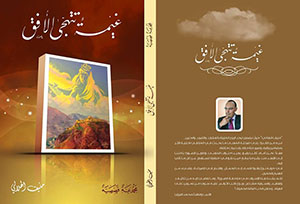- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
- بعد أن تلقوا ضربة أمريكية موجعة... الحوثيون يعلنون خفض التصعيد في البحر الأحمر
- مسلحون حوثيون بقيادة مسؤول محلي يقتحمون منتجع سياحي في الضالع للبسط عليه
- جزيرة كمران.. قاعدة عسكرية لإيران (تفاصيل خطيرة)
- "تهامة فلاورز" مشروع الحوثيين الوهمي للاستيلاء على أموال اليمنيين وأراضي الدولة

طه الجند نسيج وحده – لا مفر من استعمال تعبيرات القدماء – فهو مخلوق من شعر خالص، إنه قصيدة تمشي على الأرض، وهو إذا قررنا أن نتعامل مع اللحظة التي عرفناه فيها شاعراً أقصد نهاية تسعينيات القرن الماضي سيعدُّ نابغة بكل معنى الكلمة، فقد قدم ديوانه الشعري الأول "مراث لزمن الجراد" سنة 2000، وكان عمره حينها 37عاماً، وكنا نظنه مثل أكثر الكتاب والمبدعين اليمنيين ممن يهملون تجاربهم الإبداعية أو نتاجاتهم المكتوبة بشكل عام، وقليل منهم من حاول نشر جزء من إبداعاته وكتاباته - وهذا القليل - حين يفعلون ذلك - يقومون به في وقت متأخر نسبياً عند البعض، ومتأخر جداً عند بعض آخر، وهناك بعض يتولى مهمة نشر إبداعهم أصدقاء لهم وتجيء المبادرة في الغالب بعد فوات الأوان، أعني بعد رحيلهم إلى الحياة الآخرة.
لكن طه الجند أخبرني وهو يضحك ويسخر من نفسه كالعادة أنه رغم شغفه المبكر بكتاب يمنيين كالبردوني وعبدالودود سيف والمقالح وأدباء عرب مثل محمود درويش والبياتي وأمل دنقل وغيرهم، إلا أنه عاش سنوات طويلة وهو يتردد في دخول عوالم الكتابة، فالكتابة لم تكن مشروعاً له، لم يعتبرها هدفاً، أو مآلاً لحياته، وما هو عليه اليوم بوصفه شاعراً متفرداً تحظى تجربته باحترام كبير لم يكن ليخطر على باله حين كان في الخامسة والثلاثين من عمره.
كان الجند يحلم بمشاريع أخرى، مشاريع كان يعتقد – ومازال – أنها يجب أن تكون هدف جموع الشعب الكادحة، من فلاحين وعمال وأصحاب حرف ممن يصنعون الحياة وبهم تدور عجلتها، وبهم يجب أن يتغير الواقع أو ينتزع انتزاعاً من سرّاقه ومن مزيفيه الذين لن يكونوا سوى حفنة من المتسلطين وذوي الجاه والنفوذ.
ولد طه الجند في قرية الجند - بني مسلم، وصاب العالي سنة 1963، من أسرة معروفة تنغرس جذورها في تأريخ فقهي وصوفي تتذكره كتب التأريخ والطبقات جيداً وإن بدا غابياً اليوم على كثيرين حتى من أبناء الأسرة نفسها، رغم ممارساتهم اليومية لطقوس شعبية وروحية تعطر النفوس، والأمكنة بروائح ذلك التأريخ، أما ما تعرفه الأسرة يقيناً فهو انغراسها في التربة الفلاحية المنتجة والمواطنة الصالحة كما يجب أن تكون، وهذا ما يفاخر به طه الجند ويعتبره النسب والحسب الذي يليق به كمبدع ويليق بسائر اليمنيين أيضاً لأنه حقيقتهم الأجلى.
كان قدر أي صغير يتخطى الثانية عشرة أن يتوجه في الغالب إلى السعودية حيث كانت الطفرة النفطية قبل منتصف السبعينيات من القرن الماضي في ذروتها، وكان السفر سبيلاً لجني المال والبقاء في الغربة أو العودة بعد وقت لترتيب وضع ما، قليلون هم الذين يبقون في حضن الأرض وصحبة الزرع والماشية، وأقل من القليل من يواصلون دراستهم، وكان هو من هذا "الأقل" الأخير، فبعد أن أنهى دراسته الابتدائية في وصاب انتقل إلى صنعاء حيث التحق بمعهد الشوكاني للمعلمين، ومنه تخرج بعد سنوات لينخرط في التعليم زمناً قبل أن يكمل دراسته في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء. ويواصل من ثَمّ أداء رسالته تربوياً ثُمّ موجهاً.
***
أما صلة الجند بالثقافة والكتاب فقد بدأت في أسمار قريته وفي لياليها الرمضانية بالذات حيث تمتزج الحكايا الشعبية بالقراءات التي تمر من القرآن الكريم إلى كتب مثل الإسراء والمعراج لتنعطف إلى الحكايات، مقروءة هذه المرة وممثلة بـ"ألف ليلة وليلة" فاتحة للخيال آفاقاً لا حدود لها، وكما حدث بالضبط للكاتب والباحث محمد سالم الحداد على تباعد الأمكنة وانعدام المعرفة بينهما، فقد شهدت صلة الجند بالكتاب - في نفس السنوات بالضبط "مطلع السبعينيات" - تطوراً حين بدأ يتعرف على مجلة العربي في بيت عمه، واكتشف أن فيها شيئاً مختلفاً بالنسبة له، اللغة غير اللغة التي ألفها في تلك الكتب الصفراء، والورق له روائح مميزة، وهي تنتقل بهذا القارئ الصغير بين كتّاب كثيرين وبلدان متباعدة، وتفتح عينيه على الصورة واللون كما تفتحهما على فضاء المعرفة عربياً وإنسانياً.
لكن هذا لم يكن المنعطف الحقيقي في حياة الجند رغم أهميته كمدماك أول في تكوينه، فالمنعطف الحقيقي بدأ عقب التحاقه بمعهد الشوكاني للمعلمين، حين وجد نفسه بين طلبة ينتمون إلى جهات شاسعة من اليمن، كما وجد نفسه وسط العاصمة مركز السلطة والنشاط السياسي والثقافي. وكانت تلك فترة السبعينيات من القرن العشرين وهي فترة شهدت فيها اليمن ذروة الأمل في المستقبل قبل أن تتوالى عليها الفواجع والانكسارات.
انضم طه الجند –في تلك الأثناء - مع عدد كبير من زملائه المتحدرين من أسر فلاحية ريفية إلى العمل السري من خلال حزب الوحدة الشعبية الذي كان فرعاً في شمال اليمن– إن صح التعبير- للحزب الاشتراكي اليمني الذي كان صوته يعلو في جنوب اليمن على كل صوت،
وبسبب نشاطه وحماسه وإيمانه بما يفعل فقد صار بعد وقت قصير مسؤولاً عن الإذاعة في المعهد، ومسؤولاً أيضاً عن حلقات التوعية والمجلات الحائطية، وصاحبت تلك الأنشطة قراءات موجهة وأخرى حرة، كما صاحبتها مثاقفات وتجارب أنضجت وعيه، ووسعت مداركه ليبدو شاباً يجمع بين الشجاعة والاندفاع، وتضج روحه بعرم الحماس للمبادئ والتوجهات التي يحلم بها ويتوقع لها أن تمتلك الغد وتغدق العدل والمساوات والحياة الكريمة على جموع الفقراء من فلاحين وعمال وحرفيين ممن يمثلون سواد الشعب الأعظم، وترزح رقابهم تحت نير المظالم والدكتاتوريات المتخلّفة وأساليب الحكم التقليدية التي تعوق البلاد عن الانطلاق إلى المستقبل،
وقد أهّله نضاله وحماسه وتوقد وعيه السياسي والاجتماعي أثناء فترة دراسته في المعهد ليكون قائداً للعمل السياسي أيام الجبهة في مناطق وصابين وعتمة، وتلك تجربة أخرى صهرت روحه وعقله وجسده، فهناك وضع كل الأفكار والقيم والمبادئ التي آمن بها على محك الواقع العملي حيث يمكن للكلمة أن تتحول في أي لحظة إلى رصاصة تطلقها أنت، أو يطلقها الآخرون تجاهك، أو تجد نفسك في أهون الشرور غير قادر على الاستقرار مطارداً أو مسجوناً، وكل ذلك عرفه الجند الذي عانى وضحى وأودع السجن في وصاب مدة 4 أشهر.
***
يعتبر طه الجند نفسه واحداً من جيل الثمانينيات، وهو يعتقد أن هذا الجيل على المستوى النضالي في المجال السياسي والحزبي كما على المستوى الثقافي والأدبي أسوأ الأجيال التي عرفتها حقب القرن الماضي حظاً، فهم الجيل الأكثر تعباً وتهميشاً وتغييباً، رغم أن هذا الجيل في رأيه أفضل الأجيال وأميزها عطاءً ومبادئ وتقديماً للنافع والجوهري في الحياة العامة، فهم الذين دشنوا المساهمة اليمنية في التعليم، وذهبوا إلى مختلف مناطق اليمن وأريافها، مدنها الثانوية الصغيرة وقراها، وهم فوق ذلك آخر الأجيال المستنيرة، بل هم مفصل فارق في الحالة اليمنية، فقد كان سابقوهم ممن مثلوا توجهات اليسار والتيارات القومية نخباً تتحرك في أطر محدودة بسبب محدودية عددها، وانتساب جلها إلى أسر ذات وجاهات معينة كذلك بسبب ظروف البلد وتضييقات الأنظمة على الناشطين من الحاملين لأفكار جديدة، أما هم فكانوا مجموعات كبيرة سمتها الغالبة الانتماء إلى أسر فلاحية وعمالية وحرفية تنتمي لغمار الوطن الواسع وأهم بصمة في تكوينهم هي عرق الكد والشقاء، وروائح التراب، وآثار المهن التي جاؤوا منها، وهم يصطفون في تيارات اليسار والحركات القومية وينتشرون بشكل واسع في جميع مفاصل الوطن خاصة مجال التربية والتعليم،
كما كانوا يختلفون عمن بعدهم في كونهم – وهذا لم يتبين لهم إلا فيما بعد- آخر جيل حمل المشروع الوطني ذا الملمح الإنساني الجميل، الذي سبق انهيار الأيديولوجيا، وتهدم القيم، وانسلاخ الجلود وابتلاع العولمة للإنسان داخلنا، وقضاء التيارات المتطرفة المتمسحة بالدين على الفضاء الكبير الذي كنا نرى العالم من خلاله وينعكس على الجانب الثقافي والإبداعي كما ينعكس على المشروع الوطني تحديثاً، وتطلعاً باتجاه المستقبل،
ومن جهة أخرى فقد كان الجيل الثمانيني أكثر انتماءً للوطن، وأنجح في مجال الخدمة الوطنية، وكان الناشطون في مجالات التعليم والسياسة والثقافة من المنتمين إليه يحملون ثقافة حقيقية جامعة لمعاني التسامح واحترام التنوع، وكانوا يفعلون ذلك ومازال أكثرهم يفعله في كل مكان بتواضع ومحبة، وهم جيل كبير ورائع مقارنة بما نراه اليوم في الممارسات الثقافية والسياسية التي تُغرق الجيل الجديد في وحل المناطقية والمذهبية الطائفية وتوجهات الكراهية التي تمزق عرى الوطن وتعصف بالأواصر الإنسانية بين الناس.
لكن معضلة جيل الثمانينيات الذي ينتمي إليه الجند وظيفياً وثقافياً ونضالاً ووعياً سياسياً وإدراكاً ورؤية للعالم أنه جيل تحمل قسوة الصدمة وتحمل مرارات الهزائم في كل ما شهدته اليمن خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بمقدار ما تحمل الهدر في أحلامه وحياته المعيشية وأوضاعه كافة، فالأجيال التي سبقت جنت ثمار كفاحها صدارة في المشهد اليمني العام على مستوى المناصب والوظائف والوجاهة السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية، ونالت ما يليق بها تقديراً واحتراماً معنوياً ومكاسب مادية أيضاً، وكُتب تأريخها ووثّقَ لها بأشكال مختلفة، أما جيل طه الجند فقد حرم من كل ذلك، ولم تتوقف المعضلة عند هذا الحد إذ قدر لأبناء هذا الجيل أن يتعايشوا مع جيل تال تشكلَ في الواقع الجديد، وتشكل الواقع الجديد به وهو جزء منه، لكنه - وتلك مفارقة مفزعة – لا يعي حجم المصيبة التي هو فيها.
***
ما الذي أخذ بكتابتي عن طه الجند إلى هذه الوجهة؟
لقد كنت أريد الكتابة عنه فحسب، لكني كتبت عن جيل كامل، وعن أحلام ونضالات وأحزاب وعن شجون وطن كامل، لا تفسير لما فعلت سوى القول إن خصوصية الجند قد فرضت نفسها عليّ، فهو من أولئك الناس الذين تشعر أن ذواتهم تختصر الوطن في مجموع شجونه الحادة، وتختصر مراحل معينة من تأريخ أوجاعه، وتشعر أنه رجل لا يمكن الحديث عنه إلا من خلال الحديث عن الرفاق والناس ومفردات البلاد كلها، فهو يعبر عن كل ذلك من خلال صوته القوي، وطرحه الشجاع الذي يصدر عن وعي سياسي عميق، وإدراك نابع من ثقافة حقيقية وتجارب في الواقع. وهو يؤمن بضرورة حصول أبناء جيله – خصوصاً - على حقوقهم فقد ظلموا وظيفياً ومعيشياً، وضاع حقهم المكتسب بالنضال والتضحيات، وظل الفقر سيفاً مصلتاً على رقابهم. وبين براثنه تكونت عائلاتهم، وكبر تحت وطأته الأبناء والبنات، ثم هو يرفض أن يُنظر إلي أبناء جيله بوصفهم هامشاً على الحركة الوطنية، لأن ذلك حيف آخر يلحق بهم، فقد كانوا جزءاً مؤسساً في نسيج اليسار، كما كانوا فاعلين بقوة في قلب الحركة الوطنية والحراك الاجتماعي ولم يكونوا قطّ مجرد جيل عابر.
***
مع غروب سنوات القرن العشرين كان طه الجند قد كابد كأغلب المنتمين لليسار اليمني مرارات انكسار المشروع الوطني وحلم الدولة المدنية. وفيما كانت الأيام تمر كابية ثقيلة الخطى وفارغة من المعنى، راح المبدع المقموع في داخله طيلة السنوات السابقة يتبازغ متردداً بعض الشيء لكنه كان يتقدم ليعرب عن نفسه يوماً بعد يوم.
اعترف لي هو أن الشعر قد بدا له حرفة اضطرارية، رغم أنه كان يشعر دائماً أنه ستأتي مرحلة يكتب فيها.
وهذا معناه أن طه كان يشعر أنه في ناحية التعبير عن نفسه بالنضال السياسي من خلال الحزب ومن خلال كل الأساليب التي مارسها سابقاً في سبيل التحقق الذاتي قد وصل إلى طريق مسدود، وأن العمر يمضي والحياة بلا معنى وأنه حزين لكل ذلك، وأن حزنه كما عبر فيما بعد " مثل حزن الأغصان التي تسقط فاكهتها فلا يلتقطها أحد " أوأنه يعيش في وسط " أكثر حزناً " بل هو " مثل السديم الذي تتنفسه الفاكهة التالفة " وأنه من خلال الشعر يستطيع أن يُخرج بَلغم المرارات التي تمتلئ بها رئتاه وتنسدّ بها منافذ التنفس في حلقه وخياشيمه، ويستطيع التعبير عن نفسه و يوفر لها التوازن ولو إلى حين:
أخاف أنني قد مت بالفعل
ولم أنتبه
فأتشاغل بالخربشة
حتى أجد من يقرضني تكاليف الدفن
هذا كل ما في الحكاية.
لكن بواكير تجربته الشعرية التي أسفرت عن نفسها في مجموعته الشعرية الأولى " مراث لزمن الجراد " والتي طبعت سنة 2000م ظهرت شكلاً ومضموناً تحمل آثار ماضيه السياسي وفهمه للشعر الذي كان مرتبطاً بذلك الماضي، وهو فهم يجعل الشعر ضاجاً بالشعارات الطنانة ومنحازاً للمنبرية، مباشراً في مضامينه ولغته ورنين تفعيلته وموسيقاها، ورغم أن المجموعة كانت مواجهة واضحة لظروفه الشخصية والعامة، إلا أنها كتبت بشكل كان يقع وقتها خارج مدار التلقي الجديد، ومعنى ذلك أن الجند كان في وادٍ وحركة الجيل التسعيني الذي سينتمي إلى آخر موجاته شعرياً في واد آخر، ومن جهة أخرى فإن معظم من هم في مجال حركته اليومية من الشعراء والكتاب ممن يتحتم عليه أن يثاقفهم ويسمعهم ويسمعوه، وأكثرهم شباب من أواخر المنتمين لليسار، كانوا قد قلبوا ظهر المجن للالتزام بالقضايا الكبرى، وأعلنوا سقوط المعنى، وانحازوا لكتابة الذات من خلال قصيدة النثر ولغتها اليومية وتفاصيلها البسيطة.
وزاد الطين بلة أن الجند كان عديم الخبرة بالتصحيح والإخراج، وقد غالطه الطباع الذي صف له المجموعة على الكمبيوتر وسلمه النسخة غير المصححة، وحين خرجت المجموعة للنور كانت مثاراً للضحك والسخرية في كل مقيل ومقهى ومنتدى، وكثيراً ما كان أصدقاؤه يقولون له وقد علت ضحكاتهم: ليس فيها جملة يمكن أن تكون سليمة من الخطأ إلا اسمك المكتوب على الغلاف.
لكن الجند الذي يقتلنا اليوم ضحكاً كلما روى لنا قصة ظهور مجموعته الأولى، وما كان يتلقاه من تعليقات ساخرة عليها، لم يكن ليفعل ذلك لولا أنه قد استطاع في مجموعتيه التاليتين " أشياء لا تخصكم " 2004م، و " رجل في الخارج يقول إنه أنا "2008م، تحقيق معجزة إبداعية ناجحة بكل المقاييس.
وإذا كان جيل التسعينيات الذي ينتمي طه الجند إلى آخر موجاته، قد ظل يعتبر نفسه بعيداً عن أي امتداد لأجيال الشعر اليمني السابقة، فإن طه الجند لم يعترف عملياً في متحققه الشعري بجيل التسعينيات وبدعاواه كلها كما لم يعترف بغيره من الأجيال،. فقد راح يصغي إلى نفسه وأخبرته نفسه أن في ماضيه وفي حاضره وفي وقائعه اليومية ما يفوق الشعر وما يجعله غير محتاج إلى خيال يطير بعيداً، أو لغة تغرق في بلاغة بلهاء، ثم اكتشف أنه محتاج إلى مزيد من البساطة والتلقائية ليقول كل ذلك، ولعله قد عبر عن أول اكتشافاته تلك حين قال:
كم يحتاج الغريق لتجفيف جثته
والذهاب إلى الجحيم دون مساعدة الآخرين
هذا ما فكر به البحر حين رآه
أما هو فقد ابتسم لألمعيته
سأستدرج الموج إلى البر
وحين يصير حفرة ضحلة سأملؤها بالرمل
هكذا أريحه من اللهاث والتبجح
لقد فعل ذلك تماماً "استدرج الموج إلى البر" في "أشياء لا تخصكم" وراح يلاعب بحر ذاته المتقلب في محيط الحياة.
وقبل أن تذهب المجموعة إلى المطبعة وقعت بين يدي الشاعرين الراحل محمد حسين هيثم والدكتورة ابتسام المتوكل وأذهلهما عالمها الشعري المختلف، فتطوعا بمساعدته على إخراج المجموعة مصححة بشكل جيد، وكان طه قد اختار لها اسماً آخر، لكن هيثم بعد أن وقع نظره على "أشياء لا تخصكم" وهو عنوان إحدى القصائد فيها أشار عليه باختياره، ثم ظهرت المجموعة مطبوعة، وعبّرت الكتابات النقدية الكثيرة التي تناولتها عن نجاح غير عادي حققه هذا الشاعر، فقد أثبت أن أغلب توصيفات النقاد لقصيدة النثر في غير محلها،. وأن الشعر سواء كان نثراً أو تفعيلة أو عموداً أو خارج هذه التوصيفات كلها: هو كيمياء مختلفة، وروح لا يمكن تفسير كنهها، وأجبر طه كل فرقاء المشهد الشعري على الإصغاء إلى صوته الخاص،. فالذين يزعمون أن قصيدة النثر تقرأ ويتم تلقيها بصمت، وأنها لا تحفل بالموضوعات العامة لأنها قصيدة ذات، وتفاصيل صغيرة لا تعني أحداً قدر ما تعني صاحبها، وجدوا في قصيدة الجند ما يخرج بالنص عن توصيفاتهم، ولم يروا في ذلك غضاضة، بل رأوا فيه إضافة حقيقية للمدونة الشعرية الحديثة، وبالمثل وجد المتعصبون للعمود والتفعيلة في نصوص الجند شعراً يدير الرؤوس أكثر بكثير مما تفعله معظم تجارب العمود والتفعيلة.
المثقفون الحزبيون وأكثرهم من المتشبعين بتقاليد القصيدة التي كتبها شعراء الستينيات والسبعينيات وجدوا أيضاً في قصيدة الجند موضوعاً يعبر عن العام قدر تعبيره عن الخاص، ولأن أكثرهم ينتمون إلى أحزاب المعارضة التي تعرضت لانكسارات متلاحقة لأسباب مختلفة يمنية وعربية وعالمية فقد وجدوا في نصوصه ذواتهم وخصوصياتها، كما وجدوا ما يعبر عن إحباطات مشاريعهم الوطنية والثقافية والوجودية العامة.
ولعل أسلوب الجند هو ما يحببه إلى المتلقي فهو يتعامل مع الشعر بعفوية وتلقائية بالغة، ويجعل منه معبراً عن وجوده وتفاصيل حياته اليومية، وعلاقاته الاجتماعية، ومثاقفاته، وآرائه السياسية، ويمزج فيه بين نكباته ونكباتنا، ونكبات المجتمع والوطن والعالم كله، ويسجل في جزء كبير منه ردات فعله الآنية على الأحداث، التي كثيراً ما تتخذ من المفارقة الساخرة منفذاً إلى هجاء الأوضاع السيئة وصانعيها،. حين يصرخ مثلاً:
قفوا أيها السفلة
حتى نكمل الحكاية
نشعر جميعاً أن هذا صوتنا، وحين يخاطب مصادر وجعنا قائلاً:
لا نحن فقراء بما يكفي
ولا أنتم أثرياء كما يجب
وما يجمعنا هو الغبن
دعوا لنا إذاً شيئاً من الرصيف
ستدركون كم نحن مهذبون
حين تمتد أيدينا مثلكم بسلاسة للمحسنين
نشعر جميعاً أن هذا صوتنا نحن، لذلك فإن كثيراً من تلك النصوص تجد طريقها إلى الصفحة الأخيرة لبعض الصحف الواسعة الانتشار مثل "الأولى" و"الشارع" ونحن نتلقاها كما نتلقى مقالات الرأي المهمة مضافاً إلى ذلك متعة الشعر الذي نجده فيها.
لقد اتسع حضور طه الجند في حياتنا كثيراً بعد صدور مجموعته " أشياء لا تخصكم " وعندما صدرت مجموعته الأكثر نضجاً " رجل في الخارج يقول إنه أنا" كان طبيعياً أن تحظى باستقبال أوسع من النقاد والشعراء الذين تسابقوا على الاحتفاء بها، فقد صار طه الجند يمثل حالة خاصة داخل المشهد الشعري اليمني والعربي ولا نكون مبالغين إن اعتبرنا ما يقدمه تجربة عالمية، لأنها تجربة إنسانية بكل معنى الكلمة.
وكان شيئاً جميلاً أن تتقدم تجربته دون أن تتخلى عن طبيعتها العفوية، فالذي ينكتب هو طه الجند، وهو ينكتب بحلاوة وبساطة في آن، كذلك شجونه ومواجيده ومخاوف وجوده وسيرة أساه وتطلعاته ماثلة دائماً بشكل يثير الإعجاب:
الوقت ينبح في الخارج
وحيداً كمياه الينابيع
الأصابع تركض في البر
السيول تترقب المطر
وتمضي معه إلى البحر
وأنا كعجل صغير يحرك ذيله بتعجب
وينصت لما يجري بانبهار
ثم إنه يحتفي بالقصيدة قدر احتفاء القصيدة به وإعادتها الروح إليه:
الريح التي تهب على الحديقة تعيد دفقة الحياة
هنا حيث تغوص وتغرق
كتلة من الذكريات الميتة
لم تكن هناك حديقة، بل فقط وعاء للذخائر المقدسة
الخفق الذي تسمعينه ليس تحليقاً
بل مجرد اضطراب في رحم الأبدية
واستراتيجيات الجند لا تتوقف عند هذا الحد فهو لا يكتفي بتحويل مصادر الخيبات والارتكاسات والألم إلى شعر، ولا يكتفي بأن يفعل ذلك بشكل احتفالي، بل يضيف إليه عنصراً آخر أكثر فعالية فهو يقنعنا أنه يكتب كطفل يواجه قسوة العالم ومجهولاته ويواجه تحديات الوجود العابثة:
أنا خائف يا أمي
من وشوشات الليل
من رجل في الخارج يقول إنه أنا
وهو عنصر شديد الارتباط بطريقة الشاعر الخاصة التي يلقي بها شعره فكثيراً ما فشلنا في التماسك أمام أوجاع نصوصه وجراحتها المتناثرة حين يلقيها علينا، وكثيراً ما تسربت الدموع غصباً عنا، ولم يكن تسربها إلا دليلاً قاطعاً على أن وجعه الخاص هو وجعنا كلنا.
***
بشكل عام فقد عوض طه الجند في ساحة الشعر ما خسره في ساحة النضال الوطني، ووجد فيه مصدراً للتوازن بعد الخيبات التي امتلأت بها حياته جراء الصراعات السياسية وتخبط مشاريعها وفساد رموزها، كما وجد في الشعر معوضاً آخر عن عدم القدرة على تجاوز الأزمات النفسية التي تتولد من اختناقات الحياة المعيشية، وهو وضع آخر كان مصدر ألم دائم لأن الجند كغيره من الموظفين الأنقياء لم يستطع تجاوز ظرفه الذي وجد نفسه فيه مذ ولد، وفشلت محاولاته لتغييره عن طريق المشروع الوطني الذي كان يحلم أن يسعده ويسعد غيره، ولو كان الجند في غير اليمن لكان نجاح تجربته الشعرية كافياً ليحقق له نجاحاً مادياً يوازي نجاحه المعنوي، لكنه يعيش هنا في اليمن، وهنا كثيرٌ عليه أن ينجح حتى معنوياً، فقد كُتب عليه أن يبقى في حفرة المتاعب، وأن يظل لسان حاله ولسان حالنا جميعاً كما قال:
في حيز لا يكفي نملة
أفكر وأزحف
أقامر وأدور
أحزن وأفرح
أشيخ وأموت
منقولة من صحيفة الأولى بعددي 5و6 أغسطس 2014م.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر