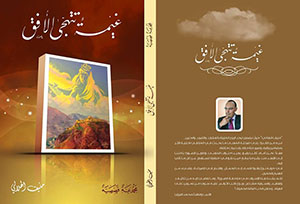- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
- بعد أن تلقوا ضربة أمريكية موجعة... الحوثيون يعلنون خفض التصعيد في البحر الأحمر
- مسلحون حوثيون بقيادة مسؤول محلي يقتحمون منتجع سياحي في الضالع للبسط عليه
- جزيرة كمران.. قاعدة عسكرية لإيران (تفاصيل خطيرة)
- "تهامة فلاورز" مشروع الحوثيين الوهمي للاستيلاء على أموال اليمنيين وأراضي الدولة
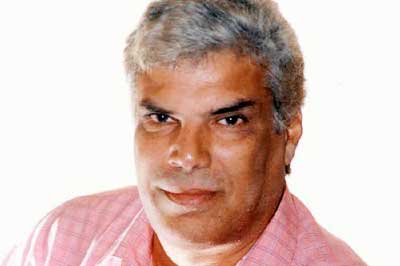
في صباح يوم السبت الموافق اليوم الثاني من هذا الشهر، وهو بالمناسبة يوم مولدي، جلست أشرب قهوتي وأمامي صفحة الفيسبوك، فوجدت سؤالا من الكاتبة الشابة منة الله أبوزهرة تصرخ فيه أين الاستاذ مكاوي سعيد. إنه لا يرد على تليفونها. كان هلع الكاتبة الشابة كبيرا بحق، ما جعلني أطلب مكاوي في التليفون، لكن للأسف لم أتلق أي رد.
بعد دقائق صرخت الكاتبة الشابة بأن مكاوي سعيد مات. أصابتني صدمة حقيقية. قفزت إلى وجهي على الفور صورته حين قابلته قبل ذلك بثلاثة أيام. كنت جالسا في مقهى البستان ورأيته يقبل نحوي وكان في وجهه شيء من الشحوب وشيء من النور الهامس. سألته مالك يا مكاوي؟ قال لا شيء. قلت له شكلك مرهق أو تعبان، قال مبتسما كعادته «عادي».
مضت ثلاثة أيام ثم انتشر خبر موته في حزن كبير على صفحات الفيسبوك. جلست أبكي ثم هيأت نفسي للخروج من البيت ومعي زوجتي، والذهاب إلى مسجد السيدة نفيسة كما عرفنا للصلاة على جثمانه، ثم إلى المقابر لدفنه.
سكني بعيد عن مسجد السيدة نفيسة، لكنني نسيت كل شيء إلا أن أطل الطلة الأخيرة على مكاوي سعيد. البكاء منفردا في البيت سيقتلني. لقد تم كل شيء بسرعة مدهشة، كأنه يستعجل الرحيل حتى بعد موته. فالصلاة عليه بعد صلاة العصر وهناك في باحة المسجد وجدت الدموع أمام وجوه الجميع. الرجال والنساء. مكاوي سعيد الذي يراه أي شخص كل يوم لو أراد في مقهى البستان صباحا أو مساء، لا يمكن أن يرحل، إنه علامة من علامات وسط البلد الثقافية وعنها كتب مقالاته ورواياته. هكذا قال الجميع معبرين عن صدمتهم بحق.
في الساعة الرابعة كنا انتهينا من الدفن في مقابر باب الوزير. عدنا معظمنا إلى المقهى. حاول بعضنا أن يخرج من الحزن إلى الحديث في أي شيء. وحاولت أنا. قلت أجدادنا الفراعنة كانوا يدفنون مع الموتى الأشياء التي أحبها المتوَفى في حياته. هل كان ممكنا أن ندفن معه اللابتوب أو التابلت الصغير، فمكاوي في المقهى كثيرا ما ينفرد بأي من الجهازين عن كل الجالسين ويكتفي بالتحية والابتسامة. قال البعض لا. «البيريه» هو ما لا يستغني عنه. دقائق ولم أستطع الاستمرار في الجلوس. أردت الانتقال إلى مكان ثان. كل ما كنا سنقوله لن يخرجنا من الحزن الحقيقي. للأسف لم أستطع الذهاب في اليوم التالي إلى العزاء. الآن إذا خرجت من بيتي يوما لا بد أن أستريح عدة أيام فسكني بعيد عن وسط المدينة والصحة لم تعد تساعد، ثم إني أريد أن أنفرد مع مكاوي سعيد. أتذكر لقاءنا الأول في أواسط التسعينيات من القرن الماضي حين كنت أنا رئيسا لتحرير سلسلة «كتابات جديدة» وقدم لي مجموعة قصصية جميلة عنوانها «فئران السفينة» ونشرتها. كنت أعرفه معدا لأفلام تسجيلية في التلفزيون المصري، وكان كثيرا ما يحدثني ذلك الوقت عن أحلامه في التأليف السينمائي، التي لم يمشِ وراءها، لأن الرواية جذبته كموهوب كبير، حتى إنه حين أصدر روايته «تغريدة البجعة» ووصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة البوكر في دورتها الأولى، أصبح كاتبا ملء السمع والبصر في مصر وخارجها. سافرنا بعدها مرة إلى الرقة في مهرجان عبد السلام العجيلي حين كانت الرقة على وجه الأرض قبل أن ينالها ما نالها من إجرام من يسمون بالإسلاميين. وفي الطريق في المطار عرفت إنه يملك جواز سفر سودانيا. لم أسأله عن السبب، عادة لا أسال عن الأمورالشخصية لأحد. فكرت أن والده سوداني وأمه مصرية، وحتي اليوم لم أسأله حتى حدثني هو ضاحكا منذ عام تقريبا أنه تقدم إلى إحدى الجوائز العربية وأرسل إليها صورة من جواز السفر ضمن الأوراق المطلوبة فأرسلوا يسألونه هل يعتبرونه سودانيا أم مصريا؟ فقال لهم مصري طبعا. كان مندهشا من السؤال ليس استنكارا للسودانية، ولكن استنكارا لمن لا يعرف إنه ولد ويعيش على أرض مصر وفي حبها كتب أعماله كلها. ساعتها ضحكت وقلت له كنت قلت لهم يعتبرونك سودانيا فتكون فرصتك أكثر، فالمصريون كثيرون جدا في التقدم إلى الجوائز. وضحكنا.
كانت روايته «أن تحبك جيهان» نقلة كبيرة في كتاباته، رغم أنها لم تفز بجوائز عربية رشحت لها. كنت أريد أن أتذكر وحدي أيام الثورة في ميدان التحرير وكيف كنت أقابله دائما بعيدا عن المثقفين بين الناس العاديين وأضحك، وأعرف أن لديه الأمل كما كان لدينا كلنا، لكنه يريد أن يكتب عمن لا يعرفهم المثقفون، وفعل ذلك في كتابه «كراسة التحرير». لم يكن مكاوي مرتاحا كثيرا لنتائج بعض الجوائز، لكن غضبه كان لا يزيد عن دقيقة. دقيقة حتى يبتسم وينتهي الأمر. وكانت كتابته هي حياته مثل كل كاتب. كان يختلف في دأبه عما يبحث عنه. ويقال إنه لم يكتب فقط عن وسط البلد، لكن لديه كثيرا من المقتنيات التي تعود إلى المكان. للأسف لم أذهب إلى بيته لأرى، لكن البعض يتمنى ومنهم أنا أن تكون هذ المقتنيات جزءا من مكتبات القاهرة الكبرى. لكنني لم أقل بعد أهم ما كان مكاوي فيه مختلفا عن غيره. باختصار رأيت في حياتي كثيرا من الأشرار في الحياة الثقافية. رأيت حروبهم القذرة على الموهوبين، التي تشتد حين يتبوأ أحدهم مركزا ثقافيا، وهذا ما يمنعني من أن أكتب مذكراتي الثقافية، فلا أريد أن أتذكرهم ولا أن أتذكر شرورهم. مكاوي سعيد لم يكن شريرا أبدا. كان جميل النفس والروح. غضبه سوداني فيه من العاطفة أكثر مما فيه من العقل، لذلك كان ينتهي في لحظتها وينفرد بالفراغ لما هو أجمل. لذلك أحببت مكاوي سعيد ولذلك بكيت ولذلك لم أحتفل بيوم مولدي مع أسرتي. وما زلت لا أتصور أني سأذهب إلى وسط البلد فلا أجده. كنت أتمنى أن ترثيني أنت يا مكاوي. أنت الذي كتبت يوما منذ عامين مقالا لا يزال يدق به قلبي عنوانه «في محبة » ولم يكن بيننا قط منافع من أي نوع .
٭ روائي مصري
منقولة من القدس العربي ..
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر